|
|
#1 |
|
حال جديد
|
إطلالة تاريخية:- بداية يجب التذكير بأن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية قد تم وأنه يُعد مكسبا ثميناً للشعب اليمني بأكمله، وهو مكسب لا ينبغي النيل منه التفريط به بأي شكل من الأشكال، مهما توافقت أو تناقضت مصالح ورؤى الأطراف السياسية في الساحة اليمنية، وأن الوحدة قد وفرت المؤسسات السياسية الكفيلة بتوفير فرص مناسبة لإدارة الصراعات السياسية من خلالها، ووفقاً للقواعد المشروعة المتعارف عليها في كل بلاد العالم، بعيداً عن اللجوء إلى وسائل العنف المسلح، أو أي منطق يدعو لإعادة تقسيم البلاد من جديد، وكأن التقسيم هو حكمتنا الضالة في تحقيق دولة المؤسسات والقانون، فلو أن التقسيم كان حلاً ناجعاً للمشكلات التي تعاني منها شعوب العالم لأصبح التقسيم شريعة كل عاقل، ولأصبح في مجتمعنا اليمني منهجاً حياتياً يطل علينا كل بضع سنين وربما أشهر كلما طلت علينا مشكلة وتوفر من يبدي رغبته في أن يصبح حاكماً على منطقة معينة من اليمن. فعلينا نحن أبناء هذا الشعب أن نتعقل ولا نندفع خلف الدعوات التي تصور لنا الوضع بأن الوحدة قد جلبت لنا الويل ونحن نعلم جميعاً أن الوحدة كانت ولا زالت وستظل هدفاً اجتماعيا وسياسياً واقتصادياً لكل أبناء اليمن، ونعلم كذلك علم اليقين أن كل المشكلات التي عانينا منها جميعاً بعد الوحدة، لم تكن بسبب الوحدة ذاتها وإنما كانت نتيجة للعديد من العوامل والمتغيرات المحلية، والإقليمية، والدولية. التي سآتي. من المؤكد أن كل مشكلة ولها حل بل أن هذه تعد من المسلمات التي لا يختلف عليها أحد تقريباً، وانطلاقاً من هذه النقطة يتعين على كل القوى السياسية في السلطة والمعارضة أن تكرس كل جهدها في البحث عن حلول لها، وأن يتم بحث كل مشكلة على حدة ومعرفة أبعادها وأسبابها والحلول المناسبة لها، وعلى قوى المعارضة تحديداً أن تثبت وجودها في الشارع بتقديم نفسها كبديل عن الحزب الحاكم في الحكم وتقدم بدائل حلول لتلك المشكلات وتسعى للترويج لها من خلال برامجها الانتخابية حتى تتمكن من الوصول إلى الحكم وتعالج تلك المشكلات، أما أن تأتي بعض القوى السياسية اليوم وتحاول إقناعنا بأن الوحدة هي المشكلة وتتخذ منها شماعة تعلق عليها نتائج أخطائها وفشلها في التغيير وتصور لنا الأمر بأن الخلاص يكمن في إعادة التقسيم وتربعها على سدة الحكم في هذا الجزء من البلاد أو ذاك متجاهلة أن الوحدة مطلب الشعب اليمني؛ فهذا أمر من وجهة نظري يدعونا كسياسيين ومثقفين إلى مراجعة التجارب السابقة وأن نتناولها بالنقد والتحليل للاستفادة من التجارب الماضية في تعزيز فرص إقامة دولة المؤسسات والقانون وتعزيز القيم الديمقراطية لما فيه مصلحة البلاد كلها، لا أن يتم ذلك من باب العودة من جديد بالدعوة إلى التقسيم والبحث عن تأصيل نظري يفتقر إلى أبسط قواعد المنطق، والبحث عن حجج تاريخية ليست سوى أخطاء شخصية من قبل قيادات حكمت البلاد سواء في الشمال أو الجنوب أو الوسط؛ وإنما من باب البحث الجاد عن الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الإخفاقات والبحث عن حلول عملية في إطار ما يتوفر من إمكانيات مؤسسية وقانونية وقنوات لتوصيل الآراء إلى أكبر شريحة من أوساط المجمع لتحويلها إلى ضغوط موجهة صوب النظام السياسي لاتخاذ السياسات الكفيلة بمعالجتها وإحداث التغيير المنشود. كما أن مرحلة ما قبل إعادة تحقيق الوحدة لم تكن حافلة بالاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشود وهذا دليل على أن منطق العودة إلى مرحلة الشطرين لا تجد في تلك الحقبة من التاريخ حجة لتبريرها، فما هو مؤكد أن تلك الحقبة كانت في كلا الشطرين مليئة بالصراعات السياسية التي قضت على كل أمل في التنمية الحقيقية، إذاً لماذا نصر على المطالبة بإعادة استنساخ تلك الصورة، واستنساخ قياداتها ونمكنها من الحكم فما الجديد في ذلك سوى إعادة تقطيع البلاد وتبديد قدراتها بين هذه الفئة الحاكمة وتلك، علماً أن مبدأ التقسيم لو سلمنا به كمبدأ لحل مشاكلنا فإن ذلك لن يقتصر على مجرد تقسيم البلاد إلى شمال وجنوب، وإنما سينطبق على كل إقليم الدولة، فكلما توافرت هناك مشكلة في أداء النظام الحاكم في أي وقت وعلى أي مستوى، وظهر هناك من يعدنا بأنه سيحقق لنا الأمن والرخاء قمنا بمساعدته في استقطاع جزء من البلاد ليحكمنا ويعود بدوره بمصادرة حريات الناس وتجميد العمل بالمؤسسات لأنه سيدعي حينها أن النظام والأمن القومي في خطر من الجيران والعفاريت، فهذه هي الدروس التاريخية التي يجب علينا أن نستفيد منها يا إخوة، أليس هذا ما حصل من قبل كل الأنظمة العربية وما زال، إذا المشكلة والحل ليست في الوحدة أو إعادة التقسيم, ولو كانت كذلك لدعونا إلى التقسيم كلنا. ثم أن أكبر الأحزاب السياسية في الساحة كانت بعد إعادة تحقيق الوحدة في سدة الحكم، فهل كان أدائها يرتقي إلى مستوى الطموحات التي كانت لدى الجماهير؟ أم أن كل حزب انشغل بتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية له والانشغال بتوزيع المناصب بينهم وترك مشكلات الشعب وهمومه للقدر؟ طبعاً ليسو سواء في حجم المسئولية لكن دعونا فقط ننظر إلى المدخل الذي اعتمدته تلك الأحزاب في إدارة العملية السياسية، فالمنهج الذي اتبعته واحد وهذا هو ما يهمني في إثبات زيف إدعاءاتها، وكان نتيجة كل ذلك بأن فقدت تلك القوى الثقة ببعضها بعض حتى انتهى بها المطاف إلى إدخال البلاد في أتون حرب أهليه ذهبت بالكثير من منجزات شعبنا أدراج الرياح، واليوم نرى بعض القوى تغطي عيوبها وفشلها بالدعوة من جديد إلى إعادة التقسيم وكأن لا هم لها سوى التفكير في تدمير خيرات هذا الشعب. وتعليقاً على بعض ما قرأته في هذا الموقع المتميز رأيت أن من واجبي الإدلاء بدلوي كواحد من أبناء هذا الشعب في الحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالوحدة اليمنية، راجياً من الكل التعليق والنقد البناء كل ما وسعهم ذلك فالهدف ليس الترويج للأفكار الواردة في هذا المقال ومحاولة إقناع الآخرين بضرورة الاقتناع بها وتبنيها، إنما الهدف الأساسي هو إثراء هذا الموضوع الحيوي بأكبر قدر من الأفكار التي من شأنها تعظيم فرص الحلول لمشاكلنا. وأرجو فقط أرجو من الإخوة النقاد التركيز أكثر على المدخل النظري لمعالجة المشكلات القائمة، أكثر من مناقشة الوقائع التاريخية فالتاريخ كفيل بكشفها مستقبلاً، فنحن أبناء اليوم مهمتنا هي البحث عن حلول لمشاكلنا الراهنة. ومساهمة مني في التعليق على بعض الآراء أورد لكم جزء من إحدى الدراسات التي تناولت بعض الأمور التي حدثت حول عملية الوحدة وهي أمور أدعوكم إلى التعليق عليها وتصحيح ما قد يرد فيها من أخطاء بحقائق أخرى مدعم بالأدلة حتى نتمكن جميعاً من فهم ما حدث فهما صحيحاً. يبدأ هذا الجزء من الدراسة بالقول لكي لا يعتقد البعض أن الوحدة اليمنية التي قامت في 22 مايو 1990، ما هي إلا مجرد وحدة سياسية بين دولتين جمعتهما المصلحة المشتركة في ظرف من الظروف، فإنه ينبغي التذكير ولو بشكل مختصر بالحقائق التاريخية التي تؤكد وحدة اليمن أرضاً وإنساناً عبر العصور. أولاً: وحدة الإنسان اليمني. "ينحدر العرب من جدين هما "قحطان" أبو العرب العاربة أو عرب الجنوب، و"عدنان" أبو العرب المستعربة أو عرب الشمال. وإلى هذين الجدين تنتسب القبائل العربية في اليمن والحجاز وشبه الجزيرة العربية. ويرى "فضل أبو غانم" أن النسابين والمؤرخين على حد سواء يكادون يجمعون على أن قبائل اليمن كافة ترجع في الأصل إلى "قحطان" الجد الأول لعرب الجنوب وهذا النسب يعتبر معزولاً بالنسبة لأنساب القبائل الحجازية التي تنحدر من أصل "عدنان" ومن ثم تؤكد المصادر التاريخية المختلفة أن القبائل العربية المختلفة قد احتفظت بأنسابها، وذلك من نقطة البدء "قحطان أو عدنان" وانتهاء بالقبائل والبطون والفروع التي كانت تنبثق عنها، وكذلك بالسلالات المنحدرة من كل فرع" . وعلى الرغم من "أنه من الصعوبة بمكان التتبع الدقيق والعلمي لرابطة النسب ونقائها لأي شعب من الشعوب إلا أن "استقراء تاريخ اليمن الاجتماعي والسياسي، وكذا ملاحظة الواقع اليمني المعاصر يدفع إلى القول بأن اليمنيون ما يزالون يتمسكون بما يمكن تسميته بـ"الشعور القرابى المشترك" بغض النظر عن حقيقة أو وهم هذا النسب . ثانياً: وحدة الأرض.جغرافية اليمن عند بعض المؤرخين والجغرافيين العرب. عُرفَت اليمن قديماً باليمن السعيد أو اليمن الخضراء لكثرة أشجارها وزروعها خاصة إذا ما قورنت بالفلوات التي تجاورها في شبه الجزيرة العربية. وتحت هذا العنوان: اليمن الخضراء، كتب المؤرخ والجغرافي "الحسن بن يعقوب الهمداني"، المولود بصنعاء سنة 280هـ أهم مرجع، وهو صفة جزيرة العرب، اعتمد عليه كل من تبعه من المؤلفين العرب في مجال وصفهم الجغرافي للجزيرة العربية، وفيه ذكر أن اليمن سميت بالخضراء لكثرة أشجارها وثمارها وزروعها والبحر مطيف بها من المشرق إلى الجنوب فراجعاً إلى المغرب ويفصل بينها وبين باقي جزيرة العرب خط يأخذ من حدود عُمان ويَبْرين إلى حد ما بين اليمن واليمامة فإلى حدود الهجيرة وتَثْليت وأنهار جرش وكتنة منحدراً في السراة على شَعف عنز إلى تهامة على أم جَحْدم إلى البحر حذاء جبل يقال له كُدُمُّل بالقرب من حِمضة وذلك حدّ ما بين بلد كِنَانة واليمن من بطن تُهامة. ثم يصف الهمداني إحاطة البحر باليمن مبتدئاً من دُما على الساحل العُماني ومنتهياً بساحل حِمضة شمال المخلاف السليماني المعروف بسم جيزان. ويتضح من هذا الوصف – كما يقول د. عبد الكريم الإرياني – أن بلد عُمان الذي يُجمع أنساب العرب ومنهم الهمداني نفسه على أن سكانه من الأزد القادمين من مأرب لا يُعدّ جغرافياً من بلاد اليمن، كما كانت معروفة في ذلك الحين أي قبل ألف عام . أما عند ابن المجاور في كتابه صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز فإن اليمن هي "المشتملة على تُهامة ونجد اليمن وعُمان والمَهَرة وحَضَرمَوْت وبلاد صنعاء وعدن وسائر مخاليف اليمن، وما كان من حد السّرين فهي تنتهي إلى ناحية يَلمْلَم حتى تنتهي إلى ظهر الطائف ممتداً إلى بحر اليمن إلى بحر فارس شرقاً من اليمن، فيكون ذلك نحواً من ثلثي بلاد العرب. أما المسعودي في كتابه مروج الذهب فقد نص على أن بلد اليمن يبدأ شمالاً مما يلي مكة حتى عدن جنوباً، ومن وادي وَجْ غرباً حتى مفاوز وحضرموت وعمان شرقاً . وبشكل عام لا تخرج كتابات الباحثين من عرب ومستشرقين-كما يرى د. حسين عبد الله العمري- عن تلك الكتابات العربية الكلاسيكية الأصيلة منذ القرن الثالث والرابع للهجرة / العاشر الميلادي من الاتفاق في وصف بلاد اليمن وتحديد حدودها التاريخية المعروفة (من حد الحجاز شمالاً إلى حد عُمان جنوباً) وبوحدة إقليمها بمختلف أقسامه أو وحداته الإدارية التي تميز بها . الوحدة اليمنية عبر التاريخ. كما هو معروف فإن "اليمن هي من دول الشرق القديمة صانعة الحضارات وفيها نشأت حضارات معين وسبأ وحمير، ومنها امتد التواصل مع حضارات وادي النيل عبر بلاد بنت في الحبشة، ومن أرضها انطلق العرب الأوائل ينتشرون في الأرض باعثين حضارة خالدة" "وقام في اليمن العديد من الممالك القوية المزدهرة ذات الشأن ولكنها في سنوات الضعف تعرضت للغزوات الخارجية التي عملت على تمزيق وحدتها وإضعاف ملكها" "وكان دخول أهل اليمن في دين الإسلام نصراً معززا دفع باليمنيين إلى الصفوف الأولى لحمل لواء الفتوحات الإسلامية ونشر دين الله في مشارق الأرض ومغاربها" . "وفي العهد الإسلامي قسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد إلى ثلاث ولايات، هي صنعاء والجند وحضرموت، تحت إمرة "معاذ بن جبل" وفي العهد الأموي ظل اليمن موحداً" . ومع بداية تفكك دولة الخلافة العباسية تمكن "محمد بن عبد الله بن زياد" سنة 205هـ من تأسيس دولته المستقلة عن الدولة العباسية في اليمن، وحكم حضرموت والشحر وأبين ولحج وعدن والتهايم والجند وصنعاء وصعدة وبيحان ونجران وجرش ...الخ، وبذلك تمكن من إقامة دولة يمنية امتدت من ظفار إلى مكة المكرمة ومع أواخر القرن الثالث الهجري بدأ الضعف يدب في عضد الدولة الزيادية فتمكن بعض الحكام المحليون من بسط سيطرتهم على بعض المناطق من الدولة الزيادية، غير أن ذلك التمزق لم يدم طويلاً حيث تمكن "أبي الحسن الصليحي" في عام 439هـ من بسط نفوذه على اليمن بما فيه حضرموت والشحر وغيرهما وامتد حكمه ليشمل مكة المكرمة . عندما انتهت الدولة الصليحية بموت الملكة "أروى بنت أحمد الصليحي" سنة 532هـ 1138م، تجزأت اليمن إلى عدة دويلات متحاربة متصارعة منها الحاتميين في صنعاء والزريعيين في عدن، والمهديين في زبيد، وغيرهم، واستمرت التجزئة في عهد الأيوبيين إلى أن تولى "عمر بن علي بن رسول"، الذي كان قائد الجيش في عهد الحكم الأيوبي، حكم اليمن بعد وفاة الملك المسعود واستمرت الدولة الرسولية قرابة قرنين 626-858هـ، واتخذ الرسوليون من تعز عاصمة لهم. واستطاعوا مد نفوذهم في كل جنوبي اليمن ثم امتد نفوذهم إلى صنعاء وبعض المقاطعات الشمالية، ويصف القاضي الشماحي الدولة الرسولية بأنها أعظم دولة وطنية يمنية عرفها التاريخ اليمني منذ سقوط الدولة الحميرية، فقد عمت النهضة في البلاد وساد التعمير، وانتشرت العلوم، ونبغ من أفرادها علماء عباقرة في الطب والرياضيات والتاريخ. ويعد الملك المظفر بن يوسف بن عمر أكبر شخصية في الدولة الرسولية، إذ اتسعت المملكة والحكومة المركزية في عهده حتى شملت حضرموت وصعدة. وفي نهاية عهد بني رسول دب الخلاف بين الأمراء الرسوليين فانتهز بنو "طاهر" الفرصة، وكان لهم مقام الوزارة مما جعلهم يتطلعون إلى الحكم الذي انتزعوه من بني رسول عام 858هـ. وقد أسس الدولة الطاهرية علي بن طاهر بن حاج الدين وأخوه عامر بن طاهر اللذان كانا وآليين لآل رسول على عدن، وبدأت الدولة الطاهرية في لحج وعدن، وحاولت توحيد اليمن، ومع ذلك فقد ظل اليمن مقسماً بين الأئمة الزيديين في المنطقة الجبلية الشمالية، والطاهريين في الجنوب حتى عهد "عامر بن عبد الوهاب" 1489-1517م، الذي نجح إلى حد كبير في ضم البلاد تحت سلطانه، وفي عهده كانت عدن مركزاً تجارياً كبيراً . واتخذ من صنعاء عاصمة لدولته بعد أن استولى عليها عام 910هـ . في عام 923هـ انتهت الدولة الطاهرية بمقتل عامر بن عبد الوهاب في ضواحي صنعاء على أيدي المماليك الذين غزو اليمن وتمكنوا من حكمه، إلى أن تمكن العثمانيون من السيطرة على البلاد في عام 1045هـ - 1517م، وظلوا بدورهم يحكموا اليمن لمدة تناهز المئة عام، وفي عهد المماليك والعثمانيون ظلت اليمن موحدة تحت إدارة الغزاة . تزعم الأئمة المقاومة ضد العثمانيين حتى تم جلائهم عن اليمن وقامت حركة ثورية لها طابع وطني سياسي بقيادة الإمام القاسم الرسي العلوي انتهت بنجاحه في تأسيس الدولة القاسمية، التي بسطت نفوذها على اليمن بأكمله في عهد الإمام إسماعيل بن محمد بن القاسم ، وامتد حكم الأئمة من ظفار شرقاً إلى المخلاف السليماني غرباً ومن عدن جنوباً حتى مشارف مكة شمالاً . وبحلول الربع الأخير من القرن العاشر الهجري بدأ الضعف يدب في مفاصل الدولة القاسمية، وبدأت الانقسامات تدب بين الأسرة الحاكمة في أعقاب وفاة الإمام المهدي أحمد بن الحسن الذي يعد أكبر قائد أنجبته الأسرة القاسمية في عام 1092، فكان ذلك سبباً في ضعف الدولة المركزية الأمر الذي مهد الطريق لانفصال بعض الأقاليم عن الدولة الأم ومن ذلك تمرد سلطان لحج وانفصاله عن الحكم المركزي في صنعاء بتشجيع من بريطانيا التي احتلت عدن لاحقاً عام 1839م" . وباحتلال البريطانيين لجنوب الوطن وسيطرة العثمانيون على شماله للمرة الثانية والأخيرة خلال الفترة 1849-1918م، وجد الشعب اليمني نفسه مطالباً من جديد باستعادة وحدته، وهو الهدف الذي ناضل من أجله اليمنيون حتى تحقق في 22 مايو 1990. مما سبق يتبين أن اليمنيين قد "عرفوا في تاريخهم القديم والحديث صوراً عديدة من السلطات المركزية التي ارتبطت بقادة محليين عظام، أو بغزاة خارجيين. وفي الحالتين كانت اليمن تتسع جغرافياً أو تتقلص مساحياً تبعاً لمساحة النفوذ الذي تتمتع به السلطة المركزية، أو بالأحرى سلطة الدولة الواحدة الموحدة، وفي حين كانت السلطة تضعف كانت تفقد بعضاً من أطرافها لحساب منافسيها المحليين من جانب، أو لغزاة خارجيين من جانب آخر" وإجمالاً "فمن استقراء التاريخ اليمني عبر العصور يتبين أن الوحدة كانت القاعدة والتمزق هو الإستثناء" "فطوال أربعة وثلاثين قرناً أمكن حصر أربعة وعشرين قرناً كانت فيها الغلبة للسلطة المركزية، مقابل عشرة قرون كانت فيها الغلبة للتجزئة والانقسام" . الوحدة اليمنية - الحدث والدلالات والأبعاد. أولاً: الوحدة اليمنية من حيث الحدث. يشير مفهوم الحدث هنا إلى ذلك اليوم الذي تمكن فيه الشعب اليمني الواحد من التغلب على قوى التشطير وقهر عوامل التمزق والانفصال، باستعادة وحدة الوطن التاريخية في 22 مايو 1990م، بعد نحو أكثر من 260 عام من ألتجزئه. عند الحديث عن الوحدة اليمنية كحدث وهدف له أهميته على كافة المستويات، فإنه يتعين علينا في البداية التعرف على الأطر النظرية للوحدة اليمنية لدى القوى والتنظيمات السياسية اليمنية، والخطوات العملية التي مرت بها عملية إعادة تحقيق الوحدة بدءاً من النقطة التي انطلقت منها، ومروراً بأهم المحطات التي مرت بها، وانتهاء بالنقطة التي توقفت عندها عشية الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م. ولعل النقطة الأبرز التي يمكن تتبع خطوات الوحدة من عندها، ترجع إلى عام 1962م، عندما قامت ثورة 26 سبتمبر في شمال اليمن، وهي الثورة الأم لثورة 14 أكتوبر التي انطلقت بعدها بنحو عام واحد في الجنوب. الوحدة في أدبيات الثورة اليمنية وبعض القوى والتنظيمات السياسية. "على الرغم من أن التجزئة مثلت حالة شاذة ومرحلية فرضت بسبب العامل الخارجي أساساً الذي شطر اليمن إلى شطرين شمالي وجنوبي، لأغراض تتعلق بالمصالح البريطانية، فإن ذلك لم يغير من حقيقة البناء السياسي والمدلول الحضاري والاجتماعي الموحد لهذه الدولة، والذي كان له دوراً كبيراً لإعادة التوحيد، لاسيما عندما تهيأت الظروف اللازمة لإنجاز هذه المهمة الوطنية" . وعلى قاعدة الوعي بوحدة الأرض والإنسان في اليمن، تواصلت المحاولات الوحدوية للشعب اليمني الواحد عبر العصور وهو ما تحدثنا عنه باختصار فيما سبق، وعندما أراد اليمنيون إعادة تحقيق وحدة الوطن في العصر الحديث، كان يتوجب عليهم أولاً العمل على تحرير البلاد من الاستبداد الإمامي في شمال الوطن، والاستعمار البريطاني في الجنوب. وبينما كانت العديد من شعوب المنطقة وشعوب العالم تكرس نضالها الوطني في مقاومة الاحتلال الأجنبي بهدف نيل استقلالها واقامة أنظمتها الوطنية المستقلة كان الأمر بالنسبة لليمن يتصف بواقع أصعب من ذلك بكثير وكانت المهام الوطنية للشعب اليمني تتسم بقدر أكبر من التعقيد مما هو لدى الشعوب الأخرى، حيث كان عليه أن يقاوم الاحتلال الأجنبي في الشطر الجنوبي، ويناضل من أجل تغيير النظام الإمامي المتسلط في الشطر الشمالي، ويعمل في نفس الوقت على تجاوز واقع التجزئة والتشطير واستعادة وحدة الوطن بأكمله . وسعياً وراء تحقيق هذه الأهداف، أعلن تنظيم الضباط الأحرار، فجر يوم 26 سبتمبر 1962، قيام الثورة ضد النظام الإمامي وشكلت ثورة سبتمبر أهم منعطف في تاريخ اليمن وأول إنجاز حقيقي نحو توحيد الوطن المجزأ وبناء الدولة اليمنية الواحدة. "لقد كانت هذه الثورة وحدوية في آفاقها وأهدافها وجسدت الترابط الحقيقي بين جماهير الشعب اليمني في الشمال والجنوب، وكان العمال والفلاحون الذين توافدوا من كل أنحاء الوطن نواة جيشها وحملة علمها. وانطلاقا من ذلك جعلت الثورة هدف قيام الوحدة اليمنية في مقدمة مبادئها" فعندما أُعلنت أهداف الثورة كان أول أهدافها: التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإذابة الفوارق والإمتيازات بين الطبقات. وبينما يشير مصطلح الاستبداد إلى النظام الإمامي في الشمال، كان المقصود بمصطلح الاستعمار الاحتلال البريطاني للجنوب. أما الهدف الخامس من الأهداف الستة للثورة فقد نص على: العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة. "ويلاحظ أن الصياغة لم تتضمن على نحو واضح القول بالوحدة اليمنية، ولكن يعتقد البعض أن عبارة الوحدة الوطنية كان يقصد بها الوحدة اليمنية، وأن الغموض والضبابية في معالجة موضوع الوحدة اليمنية في أهداف ثورة سبتمبر يرجع إلى اهتمام الثوار بإزاحة بيت حميد الدين وتثبيت الوضع الجديد في شمال البلاد، والتقليل من أخطار التدخل البريطاني الذي كان طرح شعار الوحدة اليمنية بصراحة ووضوح كفيلاً باستنفار واستثارة ردود فعله الانتقامية السريعة" . ما أن عاد بعض الثوار الذين قدموا من جنوب الوطن للدفاع عن ثورة سبتمبر إلى بيوتهم بعد أن قاموا بواجبهم الوطني إلى جانب إخوانهم في الشمال، حتى فجروا ثورة 14 أكتوبر في عام 1963، ضد الاحتلال البريطاني في الجنوب، وأثناء استمرار النضال للدفاع عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر، كانت الوحدة اليمنية هدفاً محورياً لدى الغالبية العظمى من القوى الوطنية على الساحة، وبمراجعة بعض أهم وثائق وأدبيات الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة خلال فترة التشطير يتبين مدى عمق الإيمان الشعبي ممثلاً في تلك القوى، بوحدة اليمن الطبيعية وبضرورة التخلص من التجزئة والاستعمار، وفيما يلي سوف نتطرق لبعض هذه الأدبيات، ثم عرض موجز لأبرز العوامل والمتغيرات التي أعاقت قيام الوحدة بعد استقلال الجنوب في عام 1967، وبعدها سوف ننتقل إلى الحديث عن الخطوات العملية التي تم اتخاذها لتحقيق الوحدة منذ الاستقلال وحتى 22 مايو 1992. الوحدة اليمنية في بعض وثائق وأدبيات أهم القوى والتنظيمات السياسية في الشطرين في مرحلة ما بعد قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر. 1. في الشطر الشمالي. في خضم الدفاع عن الجمهورية اليمنية، ومواجهة القوى المضادة تبلورت حركة وطنية عريضة، كان من بينها تيار عام عبر عن امتدادات قبلية واضحة، في ما عُرف بـ"القبائل الجمهورية" التي ساندة الثورة . وكان من بين أبرز ما تمخض عن هذه الحركة من وثائق في تلك الفترة "وثيقة العمل الوطني للجمهورية العربية اليمنية" التي تم التوصل إليها في 16 يوليو 1965م في اجتماع ضم فعاليات القبائل وعناصر وطنية ذات فكر تقليدي ومن بين أهم ما جاء في هذه الوثيقة عن الوحدة هو تأكيدها على ضرورة إشاعة الثقافة الوطنية، ووقوف الشعب في جبهة واحدة في وجه الرجعية والاستعمار وذلك حينما نصت الوثيقة على أن "إشاعة الثقافة الوطنية والانخراط في العمل الوطني وإيجاد التنظيمات الجماهيرية وبروز الجبهة الوطنية والتنظيم الشعبي ووقوف الشعب في وجه الرجعية الملكية والاستعمارية وعلى جبهة واحدة يساعد بدوره على صهر الوحدة الوطنية وتعميقها" . وإبان حصار السبعين يوماً لصنعاء في نهاية عام 1967 ومطلع عام 1968، لم تكن الوحدة اليمنية بعيدة عن أذهان وتفكير قوى المقاومة الشعبية الذين أتوا من كل حدب وصوب للدفاع عن الجمهورية، التي تشكلت من الأحزاب الوطنية والقومية السرية، والنشطاء اللاحزبيين في الشطر الشمالي، إضافة إلى مناصريهم من الجنوب، وقد أصدرت حركة المقاومة الشعبية "مشروع ميثاق العمل الوطني على مراحل" تضمن رؤيتها للوحدة اليمنية ولعدد من القضايا الوطنية الأخرى. وفي مشروع الميثاق هذا طرحت مهمة إقامة الجمهورية الوطنية الديمقراطية اليمنية الواحدة، وتم التركيز على أن مهام الثورة في الشمال وفي الجنوب واحدة، وأن توحيد اليمن تتوفر له كل الشروط مثل وحدة التاريخ والعادات وغير ذلك، إلا أن تلك المهمة ينقصها عنصر واحد فقط ألا وهو التنظيم السياسي الواحد لكل القوى الثورية اليمنية، كما تضمن البند الأول من مشروع ميثاق العمل الوطني المقترح خطة لتوحيد اليمن . في عام 1982 تأسس حزب "المؤتمر الشعبي العام" كتنظيم سياسي عام ينضوي تحته كافة التيارات السياسية والفكرية في شمال اليمن، ويعتبر الميثاق الوطني الذي أُقر في أول اجتماع للمؤتمر الشعبي العام في أغسطس عام 1982، بمثابة وثيقة فكرية وسياسية تبين آفاق وتوجهات الحزب ورؤيته السياسية تجاه القضايا الوطنية والقومية والإسلامية والدولية، ومن أبرز ما تضمنه الميثاق عن الوحدة اليمنية: "أن الوحدة اليمنية هي قدر شعبنا في شمال الوطن وجنوبه، وضرورة حتمية لتكامل نموه وتطوره وضمانة لقدراته على حماية كيانه وقدرته على أداء دور فاعل وإيجابي على المستوى القومي والدولي، وفي سبيل تجاوز كل التناقضات التي تعوق الوصول إلى الوحدة، فإن الالتزام بأساليب الحوار الواعي والسعي لتحقيق الوحدة بالوسائل السلمية وتوفير المناخ الديمقراطي الحر النزيه الذي يُمكّن الشعب من أن يقرر بإرادته الحرة شكل الوحدة والأسس الدستورية التي تقدم عليها وتمكنه من اختبار حكامه بملء إرادته الحرة بعيداً عن أساليب القهر والإرهاب والغش والتزوير. وبذلك نكون قد انتهجنا المسلك الطبيعي لإعادة الوحدة اليمنية بمضمونها الديمقراطي المعبر عن إرادة الشعب مستجيبين لإرادة الجماهير اليمنية صاحبة المصلحة الأساسية في الوحدة" . 2. في الشطر الجنوبي. تزعمت "الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل" قيادة الكفاح المسلح ضد البريطانيين وإخراجهم من الجنوب، وقد تأسست في صنعاء في أغسطس 1963م، بقيادة "قحطان محمد الشعبي" أحد أبرز قادة القوميين العرب بناءاً على تقرير قدمه للمشير "عبد الله السّلال" رئيس الشطر الشمالي، وكان "الشعبي" حينها قد عُين مستشاراً للرئيس السّلال لشئون الجنوب اليمني، وكان "قحطان الشعبي" قد قدم تقريره من قبل ذلك للجنة من القوميين العرب في القاهرة، وطالب في تقريره بتحرير الجنوب من الاستعمار، وتحرير الشمال من الحكم الإمامي . وقد تأسست الجبهة من سبعة تنظيمات سرية هي: الجبهة الناصرية، حركة القوميين العرب، المنظمة الثورية لجنوب اليمن المحتل، الجبهة الوطنية، التشكيل السري للضباط والجنود الأحرار، جبهة الإصلاح اليافعية، تشكيل القبائل، كما انضمت إلى الجبهة فيما بعد منظمة الطلائع الثورية لشباب جنوب اليمن المحتل، ومنظمة شباب المهرة وفي يونيو 1965م، أصدرت الجبهة القومية ميثاقها الوطني الذي تضمن رؤيتها للوحدة اليمنية، أكدت فيه على وحدة إقليم اليمن شمالاً وجنوباً وجاء في الميثاق "وعلى الرغم من منطق التجزئة الذي ساد حركة التحرر الوطني التقليدية على مستوى الشمال والجنوب إلا أن الحركة الوطنية الثورية بعد دراسة كاملة لأزمة العمل الوطني في المنطقة توصلت إلى قناعة تامة بأن تكتيل القوى الوطنية الثورية في شمال اليمن وجنوبه للنضال ضد الاستعمار والرجعية هو السبيل الثوري الجاد، فلقد كانت الحركة الوطنية في الجنوب لا تستطيع أن تباشر اتجاهها الثوري ضد الاستعمار ما دامت القوى الرجعية المتوكلية هي المسيطرة في الشمال اليمني وهي بالضرورة الحليف القوي للاستعمار. إن هذا أكد بما لا يقبل الشك أن المشاكل التي يعاني منها الشعب في الجنوب والشمال مشاكل واحدة تؤكد وحدة أراضيه ووحدة نضاله" . أما الميثاق الوطني لـ"الاتحاد الشعبي الديمقراطي" فقد جاء فيه "وترتبط قضية التحرر ارتباطاً عضوياً بقضية الوحدة اليمنية. إن الدعوة إلى الوحدة اليمنية في هذه المرحلة ليست في جوهرها إلا تعبيراً وضمانة لوحدة كفاح الشعب اليمني التي هي الشرط الأساسي لتحقيق أهدافنا المشتركة وتحرير شعبنا من جميع أعدائه. وليست فقط الحقائق التاريخية والمفاهيم العلمية لوحدة الشعوب التي تؤكد وحدة الأرض اليمنية وإنما كون الموقف في الشمال يشكل عاملاً هاماً حاسماً في تكييف وتقرير مصير الجنوب" . وتضمن "حزب الشعب الاشتراكي" في دستوره عند تأسيسه في يوليو 1962م ما نصه "تحرير اليمن شمالاً وجنوباً من الحكم الإمامي ومن الاستعمار البريطاني والحكم الرجعي السلاطيني الإقطاعي.. كما حدد الحزب مطالبه إزاء الوضع في الجنوب اليمني المحتل ومنها: حق شعب الجنوب في تقرير مصيره والتعبير عن رغبته في الوحدة مع الشمال.. وفي إطار أفكار الحزب وأهدافه خاطب موفده لجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار التي خصصت عدداً من جلساتها لمناقشة الوضع في الجنوب المحتل عام 1963م، مشيراً إلى أن حزبه يؤمن بأن اليمن الطبيعية كإقليم جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، وأن الشعب العربي في اليمن هو بدوره جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وطالب بتحرير اليمن الطبيعية من الاستعمار والرجعية" . وبعد حصول الشطر الجنوبي على الاستقلال في 30 نوفمبر 1967، وانقسام الجبهة القومية على نفسها، وانتصار التيار اليساري داخل الجبهة القومية بزعامة سالم رُبَيّع علي، وعبد الفتاح إسماعيل، وعلي سالم البيض وآخرون، على التيار اليميني الذي كان يتزعمه قحطان الشعبي قبل الإطاحة به في 21 يونيو 1968. تم إقرار برنامجاً نضالياً جديداً في أكتوبر 1968م، أخذ اسم برنامج استكمال مرحلة التحرر الوطني وقد عالج البرنامج موضوع الوحدة اليمنية، مشيراً إلى الاتجاهات الآتية : • "أن نجاح ثورة الجنوب ارتبط بنجاح الثورة وقيام الجمهورية في الشمال، ومصيرها مرتبط ببقاء الجمهورية ونجاح الخط التقدمي في اليمن الشمالي وتحقيق الوحدة اليمنية". • "الظروف الموضوعية السائدة في الجنوب والشمال عند استقلال الجنوب شكلت عوائق آنية أمام تحقيق الوحدة اليمنية". • "الوحدة اليمنية تتطلب توفر الأوضاع السياسية والاجتماعية الملائمة، كما تتطلب وحدة الأداة الثورية في الشمال والجنوب التي ستحقق وتحافظ على وحدة اليمن وعلى المكاسب الثورية التقدمية التي حققها وسيحققها الشعب اليمني في نضاله لبناء المجتمع اليمني التقدمي". • "استكمال مرحلة التحرر الوطني في الشطرين سيؤدي إلى تثبيت الاستقلال السياسي وتحرير الاقتصاد الوطني في الشطرين، وكذا سيقود إلى صنع وحدة أداة العمل الجماهيري القائدة والطليعة لشعب اليمن والقادرة على تحقيق وحدة التراب اليمني شمالاً وجنوباً". بعد ثلاث سنوات من العمل التنظيمي الموحّد الذي جمع بين التنظيم السياسي، الجبهة القومية، والاتحاد الشعبي الديمقراطي، وحزب الطليعة الشعبية. تشكل الحزب الاشتراكي اليمني، الذي عقد مؤتمره الأول في أكتوبر 1978م، وبعد مرحلة من الحوار السرّي مع فصائل الحركة الاشتراكية السريّة العاملة في الشطر الشمالي، انتهى الأمر في مارس 1979م، إلى الاتفاق على توحيد كافة الفصائل في الشطرين تحت لواء الحزب الاشتراكي الموحّد وضم الحزب الموحّد الفصائل والتنظيمات الثلاثة العاملة في الجنوب والمشار إليها سابقاً، إضافة إلى التنظيمات العاملة في الشمال، وهي: الحزب الديمقراطي الثوري اليمني، ومنظمة المقاومين الثوريين، وحزب اتحاد الشعب الديمقراطي، وحزب العمل اليمني، ولم يُعلن عن أمر هذا التوحيد في حينه، واستمر الأمر سرياً حتى ما قبل إعلان دولة الوحدة اليمنية بيومين . في تشرين أكتوبر 1978م، تمً إقرار برنامج الحزب الاشتراكي اليمني، الذي تكوّن من تسعة فصول. وتعبيراً عن الاهتمام بقضية الوحدة اليمنية جاء الفصل الأول من البرنامج بعنوان القضية الوطنية اليمنية، وفيه تمت معالجة رؤية الحزب لقضية الوحدة اليمنية وشروطها ومضمونها وكيفية تحقيقها. وفي البرنامج تحددت رؤية الحزب للوحدة اليمنية على نحو شمل نقاط عدة منها : • "الارتباط العضوي بين ثورتي سبتمبر وأكتوبر، الأمر الذي يتوّج وحدة الأرض والشعب اليمني ووحدة مصالحه المشتركة، وكذلك وحدة الأداة على صعيد الإقليم كله لكي تتمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية التاريخية للشعب اليمني". • "يدرك حزبنا والأكثرية الساحقة من جماهير الشعب اليمني الكادحة إدراكاً عميقاً ضرورة التخلص من التمزق والتجزئة ويفهمان أن تحقيق وحدة الشعب اليمني سوف يغدو مصدراً عظيماً لقوته وحافزاً جباراً لتقدمه" . • "إن الوحدة اليمنية يجب أن تكتسب محتوى ديمقراطياً، وأن تخدم قضية الثورة اليمنية" وأن تحقيقها "يثير المقاومة من قبل القوى الخارجية من رجعيين وإمبرياليين الذين يدعمون ويساندون القوى اليمنية الرجعية الأكثر تطرفاً لخلق حالة من العداء بين شطري اليمن". • "أن تحقيق الوحدة اليمنية يعتبر من أعظم وأنبل الأهداف التي ترتبط بمصالح ومصير الشعب اليمني بأسره في الحاضر والمستقبل" . مما سبق يتبين أن الوحدة اليمنية كانت من المسلمات لدى كافة القوى الفاعلة على الساحة السياسية اليمنية خلال مرحلة الدفاع عن الثورة، وكان الاعتقاد السائد في تلك الفترة، هو أن الوحدة يجب أن تتم بمجرد خروج الاحتلال من عدن، إلا أن الأمور ولأسباب داخلية وخارجية سارت على عكس تلك التوقعات وهو أمر يفرض علينا في هذا السياق التعرض له بشيء من الإيجاز على النحو الآتي:- 1) أبرز العوامل والمتغيرات التي أعاقت تحقيق الوحدة اليمنية فور حصول الجنوب لاستقلاله في 30 نوفمبر 1967م. تمحورت معظم الآراء التي حفلت بها كتابات الباحثين والسياسيين اليمنيون على وجه الخصوص فيما يتعلق بالعوائق التي حالت دون تحقيق الوحدة اليمنية عقب استقلال الجنوب حول مجموعة من العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية يمكن ذكر أبرزها في مجموعة من النقاط على النحو الآتي: • يرى البعض أن الانشقاق الذي تم في صفوف حركة القوميين العرب في أعقاب نكسة حزيران/ يونيو 1967م، والذي نتج عنه تبني بعض قادة الحركة الاتجاه الماركسي اللينيني بدلاً من التمسك بالقومية معتقدين أن التوجه القومي هو سبب الهزيمة، كان له أثر أيديولوجي في التنظيم والقيادة في اليمن، ويرى الدكتور عبد الكريم الإرياني أنه مثلما كان للقوميين دولة يرمز لها بعبد الناصر وللبعثيين دولة، كان لا بد للماركسيين من دولة تمثل الفكر ألأممي، وكان الجنوب هو تلك الدولة التي يتم إقامة نموذجهم ألأممي على أرضها، ومنها يتم تعميم النموذج على بقية الدول العربية بدءاً من الشطر الشمالي. وبالتالي وكما ذكر شاكر الجوهري عن الدكتور جورج حبش في توضيحه للأسباب التي أدت إلى عدم إعادة تحقيق وحدة الشطرين فور الاستقلال، فلم يكن متوقعاً بعد تولي السلطة في الساحة المطلوبة، أن يتم تسليمها إلى سلطة أخرى تمثل نموذجاً اجتماعياً واقتصادياً وفكرياً مغايراً في الشمال . • إن تزامن نيل استقلال جنوب اليمن في 30 نوفمبر 1967 مع حصار صنعاء في أول ديسمبر من ذلك العام، بمشاركة نحو سبعين ألف من رجال القبائل ونحو عشرة آلاف من المرتزقة المسنودين بمؤازرة ودعم غير محدود من قبل السعودية، وما مثّله ذلك الحصار من تهديد خطير على مصير الجمهورية في الشمال، قد جعل من مسألة الوحدة اليمنية وضم جنوب البلاد للوطن الأم هدفاً ثانوياً يتقدمه الهدف الأهم ويتمثل في تثبيت النظام الجمهوري في الشمال وتأكيد استقلال الجنوب كخطوة أولى بعدها يتم النظر في مسألة الوحدة . • يرى البعض أن تولي التيار اليميني المحافظ السلطة في صنعاء عقب الانقلاب الأبيض في 5 نوفمبر 1967، أدى إلى حدوث تباعد بين قيادتي الشطرين نتيجة الاختلافات في المنطلقات الأيديولوجية التي حكمت الرؤى والتوجهات في القيادتين، انعكست في تصرفات كل طرف تجاه الطرف الآخر، وترتب عليها اتخاذ مواقف متباعدة حول هوية دولة الوحدة المزمع قيامها وسبل تحقيقها، فهل تكون دولة اشتراكية على النحو الذي يريده قادة الجنوب ذوي التوجه اليساري الثوري، أم تكون دولة إسلامية إصلاحية على النحو الذي يريده قادة الشمال ذوي التوجه اليميني المحافظ . وأسهمت المحاولات القسرية التي مورست من قبل الطرفين لتحقيق الوحدة عن طريق الضم والإلحاق والتي كان أبرزها الحروب التي خاضها الطرفين خلال عامي 1972 و 1979م، واحتضان كل طرف لقوى المعارضة المسلحة من الطرف الآخر، في تعميق مشاعر العداء بين قيادتي البلدين الأمر الذي أدى إلى تراجع إمكانية قيام الوحدة في ضل تلك الأجواء المشحونة بعوامل التوتر وفي ضل انعدام الثقة بين قيادتي الشطرين. • يُرجع عبد القادر باجمال (رئيس الوزراء الحالي) عدم قيام الوحدة اليمنية عقب الاستقلال إلى أن ذلك كان يمثل هدفاً دولياً في إطار السيطرة والتقاسم، وأن الجنوب اليمني كان مهيئاً ليكون من نصيب الاتحاد السوفيتي وبالتالي فقد كانت هناك رغبة دولية في عدم قيام الوحدة اليمنية . يضاف إلى ذلك دور السعودية في محاربة مشروع الوحدة اليمنية، وهو الدور الذي تحدثنا عنه في موضع سابق من هذه الدراسة (راجع الفصل الثاني). 2) الخطوات العملية لتحقيق الوحدة اليمنية في مرحلة ما بعد استقلال الجنوب. لعل اللقاءات والاتفاقات والبيانات التي وقعت بين الشطرين منذ أكتوبر عام 1972م، حتى مايو 1990م قد شكلت أوضح الوثائق والأدبيات الجلية والواضحة لأسس قيام دولة الوحدة ونظمت النشاط الوحدوي والعلاقات بين الشطرين . ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى، تمتد من بعد الاستقلال وحتى عام 1979، وهي المرحلة التي تميزت بدخول الشطرين في صراعات دامية، وشهدت تجربتين فاشلتين لتحقيق الوحدة اليمنية عن طريق الوسائل العسكرية، أما المرحلة الثانية، والتي تبدأ من عام 1980م، فقد تميزت بدخول العلاقات بين الجانبين مرحلة جديد تميزت بالاستقرار النسبي في العلاقات بين الشطرين، وتوفر ظروف داخلية ودولية ساعدت في إتمام عملية الوحدة في 22 مايو 1990. 3) الخطوات العملية لتحقيق الوحدة اليمنية في مرحلة ما بعد الاستقلال وحتى عام 1979م. تعتبر اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس الموقع عليهما من قبل الشطرين في عام 1972، أولى الخطوات العملية الأبرز في مسيرة إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وتُمثل هاتان الوثيقتان المنطلقات الأساسية التي أستند إليها الطرفان لإتمام مشروع الوحدة في باقي الاتفاقيات التي تلت ذلك حتى قيام الوحدة عام 1990م. وقد جاءت اتفاقية القاهرة في أعقاب الصراع المسلح الذي اندلع بين الشطرين في سبتمبر من ذلك العام، والذي جاء تفجره كنتيجة لمجموعة من الدوافع التي أفرزتها أساساً التناقضات الفكرية بين النظامين في الشمال والجنوب خصوصاً تلك الرؤى والأفكار المتعلقة بموضوع إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وحدوث مواقف وتصرفات أسهمت في تأجيج حدة الخلاف وغلق باب الحوار بين الطرفين، حتى انتهى الأمر بتفجر الصراع في سبتمبر من عام 1972م. وبعد جهود حثيثة وفاعلة بُذلت من قبل جامعة الدول العربية لاحتواء الصراع اليمني- اليمني سرعان ما تم تطويقه وخلص الجانبان إلى توقيع أولى اتفاقيات الوحدة في القاهرة في 28 أكتوبر 1972م، وتصدرت الاتفاقية عبارات أكدت أن الوحدة اليمنية هي القضية الأساسية للصراع وأنها قضية المصير الحتمي للشعب اليمني الواحد، فضلاً عن أنها حاجة أساسية لتوطيد دعائم الاستقلال السياسي وبناء اقتصاد وطني مستقل وهي أيضا ضرورة قومية لأنها تمكن اليمن من المساهمة في الكفاح الذي تخوضه الأمة العربية ضد التحالف الإمبريالي الصهيوني، وتشكل خطوة جادة نحو تحقيق وحدة الأمة العربية بأسرها . كما تضمنت الاتفاقية خمسة عشر مادة فحواها اتفاق الشطرين على إقامة وحدة بينهما تذوب فيها الشخصية الدولية والقانونية لكل منهما في دولة واحدة، يكون لها علم واحد، وعاصمة واحدة، ورئاسة واحدة، وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة، ونظام الحكم فيها نظام جمهوري وطني ديمقراطي، وأن يضمن دستور الوحدة جميع الحريات الشخصية والسياسية والعامة للجماهير كافة ولمختلف مؤسساتها ومنظماتها الوطنية والمهنية والنقابية وتتخذ جميع الوسائل الضرورية لكفاية ممارسة الحريات. كما تضمن الاتفاق كخطوة أولى نحو تحقق الوحدة، ضرورة عقد مؤتمر قمة يجمع رئيسي الدولتين للنظر في الإجراءات الفورية اللازمة لإتمام الوحدة، وتضمنت الاتفاقية تشكيل ثمان لجان مشتركة على مستوى عال ومن المختصين، "تتولى توحيد الأنظمة والتشريعات، ومن أهمها اللجنة الدستورية، المختصة بصياغة دستور دولة الوحدة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها في غضون فترة زمنية أقصاها سنة تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية" . وتنفيذاً لاتفاق القاهرة عُقدت قمة طرابلس في 26 نوفمبر 1972م، بين رئيسي الشطرين، الرئيس سالم ربيع علي عن الشطر الجنوبي، والرئيس عبد الرحمن الإرياني عن الشطر الشمالي، تمخض عنها بيان طرابلس الذي تضمن تأكيد الرئيسين على ضرورة العمل من اجل القضاء على مخلفات نظام الإمامة والنظام الاستعماري في اليمن وحكم السلاطين الإقطاعي كطريق وحيد لحل معضلات الإنسان اليمني، كما تضمن البيان إقرار الأسس والمنطلقات التي سيتم بمقتضاها إنجاز أعمال اللجان المشتركة، ومنها : • يقيم الشعب العربي في اليمن دولة واحدة تسمى الجمهورية اليمنية. • مدينة صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية. • الإسلام دين الدولة، وتؤكد الجمهورية اليمنية على القيم الروحية وتتخذ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. • تهدف الدولة إلى تحقيق الاشتراكية مستلهمة الطراز الإسلامي العربي وقيمه الإنسانية وظروف المجتمع اليمني بتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحظر أي شكل من أشكال الاستغلال .. وتعمل الدولة عن طريق إقامة علاقات اشتراكية في المجتمع على تحقيق كفاية في الإنتاج وعدالة في التوزيع بهدف تذويب الفوارق سلمياً بين الطبقات. • ينشأ تنظيم سياسي موحد يضم جميع فئات الشعب المنتجة صاحبة المصلحة في الثورة للعمل ضد التخلف ومخلفات العهدين الأمامي والاستعماري وضد الاستعمار القديم والجديد والصهيونية .. وتشكل لجنة مشتركة لوضع النظام الأساسي للتنظيم السياسي ولوائحه مستهدية بالنظام الخاص بإقامة الاتحاد الاشتراكي العربي في الجمهورية العربية الليبية .. وعلى ضوء مناقشته من قبل فئات الشعب. بالإضافة إلى ما سبق تضمن البيان تسمية أعضاء اللجان ألثمان المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاقية القاهرة. "ولما كانت أعمال اللجان المشتركة تسير سيراً بطيئاً ولم تكن الفترة الزمنية المحددة في الاتفاق كافية لإنجاز أعمالها فقد استدعت الضرورة والظروف وقتها عقد لقاء قمة في الجزائر بتاريخ 4 سبتمبر 1973م تم فيه استعراض سير أعمال اللجان المشتركة" وفي اللقاء اتفق الرئيسان على أمرين هامين، الأول: عدم كفاية المدة الزمنية التي حُددت لإنجاز اللجان الفرعية لأعمالها، وأن يترك للممثلين الشخصيين الصلاحيات في تحديد المواعيد المنضمة لمواصلة أعمال تلك اللجان. وكان ذلك أول تراجع متفق عليه حول عمل اللجان الفرعية التي تحدد زمن عملها –كما ورد في اتفاقية القاهرة- في غضون عام. أما الأمر الثاني فكان الاتفاق على وجوب توفير المناخ الملائم لهذه اللجان المشتركة في أعمالها وذلك عن طريق إيقاف التدريب والتخريب في كل أنحاء اليمن وعدم السماح للعناصر المخربة بالنشاط تحت أي اسم وعدم مدها أو تدريب عصاباتها أو تشجيعها وإغلاق معسكراتها . "وقد دلل هذا الاتفاق على استمرار وجود عناصر معارضة لدى كل شطر تجاه الشطر الآخر" . وكانت الثقة المنعدمة بين الجانبين كافية لإفراغ أي اتفاق من محتواة عند التطبيق العملي للاتفاقات المبرمة بين الشطرين. ورغم ذلك فقد استمرت اللقاءات بين قيادتي الشطرين وكان ذلك يُعد بمثابة مؤشر نسبي في العلاقات بين الطرفين، ومن ذلك لقاء تعز والحديدة في الفترة من 10 – 12 نوفمبر 1973م، كما استمرت اللجان في أداء أعمالها "وفي الفترة من 21 ديسمبر 1972م حتى 16 مارس 1974م، صدر عن لجنة الممثلين الشخصيين العديد من البيانات التي أوضحت خطط ونتائج أعمال اللجان المشتركة وكذلك التوصيات التي تم رفعها إلى رئيسي الشطرين بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالأمور السياسية والأمنية والإعلامية" . أدى اغتيال الشيخ محمد علي عثمان، عضو المجلس الجمهوري اليمني، ونائب رئيس الوزراء وأحد الرموز القبلية في الشطر الشمالي، في مدينة تعز في 3 مايو 1974، من قبل عناصر موالية للنظام في الجنوب، إلى استياء شعبي طالب باتخاذ إجراءات مشددة ضد المتمردين والذين يساندونهم من الجنوب واعتُبر الحادث من وجهة نظر الشمال مبرراً قوياً لوقف عمل لجان الوحدة، وعادت مرة أخرى وبدرجة أقوى الحملات الإعلامية والمنادة من قبل القوى الشمالية على وجه الخصوص باستخدام القوة كأسلوب لإنجاز القوة . توقفت أعمال لجان الوحدة وتم الإعلان رسمياً بتعطيل العمل باتفاقية القاهرة وبيان طرابلس، وباتت المؤشرات تؤذن بإعادة تفجر الصراع من جديد بين الشطرين، لكن سرعان ما بدأت ملامح الانفراج تعود إلى العلاقات بين الطرفين مع تولي إبراهيم الحمدي الحكم في الشطر الشمالي، لاسيما بعد أن بادر الحمدي بوقف الحرب الإعلامية ضد الجنوب، وطالب بفتح صفحة جديدة من العلاقات الطيبة ونادى بالدخول في مباحثات جادة من أجل الوحدة الحقيقية بين الشطرين، ومن جهتها وجدت عدن أن التقارب مع الشمال ضروري لكسر طوق العزلة التي فرضت عليها من جيرانها ومن كثير من الدول العربية في الفترة السابقة، ومرة ثانية أخذت العلاقات في التحسن التدريجي، وتبادل الطرفان الزيارات بينهما، ومع انعكاسات الصراع الدولي والإقليمي على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، توجه الرئيس سالم ربيع علي (الملقب بسالمين) رئيس الشطر الجنوبي إلى الوطن الأم وعقد مع رئيس مجلس القيادة المقدم إبراهيم الحمدي اجتماعا في مدينة قعطبة في 15 فبراير 1977م . وخلال اللقاء تم مناقشة القضايا الرئيسية التي تهم اليمن بشطريه وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والتجارية والتنسيق في مجالات التنمية الصناعية والزراعية بما يخدم المصلحة اليمنية العليا وتم الاتفاق على تشكيل مجلس يتكون من الرئيسين ومسئولي الدفاع والاقتصاد والتجارة والتخطيط والخارجية يجتمع مرة كل ستة اشهر بالتناوب في كل من صنعاء وعدن لبحث ومتابعة القضايا التي تهم الشعب اليمني وسير أعمال اللجان المشتركة في مختلف المجالات وتشكيل لجنة فرعية من الاقتصاد والتخطيط والتجارة في الشطرين مهمتها دراسة ومتابعة المشاريع الإنمائية والاقتصادية في الشطرين ورفع التقارير عنها إلى الرئيسين مع الاقتراحات بشأنها. كما تم الاتفاق أيضاً على أن يمثل أحد الشطرين الشطر الآخر في البلدان التي لا توجد له فيها سفارات . في 11 أكتوبر 1977م وسط أجواء من التفاؤل بوجود تفاهم مشترك بين رئيسي الشطرين لإتمام مشروع الوحدة، اُغتيل الرئيس إبراهيم الحمدي رئيس الشطر الشمالي، في ظروف غامضة، وكان ذلك الحادث قد تم قبل يوم واحد فقط من زيارة كان ينوي القيام بها إلى عدن في إطار استكمال خطوات الوحدة، فأعلن الرئيس سالم ربيع علي، تعهده بالاقتصاص من قتلة الحمدي، "لكن تهديد "سالم" بالاقتصاص لم يتحول إلى أفعال عدائية ضد خليفته المقدم أحمد الغشمي، الذي حاول أن يواصل معه السياسة التي كان يتبعها مع الحمدي" غير أن مساعي "سالمين" في تطوير علاقته بالرئيس "الغشمي" ومواصلة مشروع الوحدة معه لم تكلل بالنجاح هي الأخرى، وكان السبب هو اغتيال الرئيس "أحمد الغشمي" في 24 يونيو 1978م، بواسطة حقيبة ملغومة حُملت إليه عن طريق مبعوث شخصي كان يفترض أنه من قبل "سالمين"، ويحمل رسالة شخصية للغشمي، غير أن عناصر من قيادة الجبهة القومية الحاكمة في الجنوب الذين كانوا على خلاف شديد مع "سالمين" وفقاً لإحدى الروايات، رأت في تطور العلاقات بين قيادتي الشطرين تهديداً لها، فقامت باستبدال مبعوث "سالمين" والحقيبة التي معه، في مطار عدن بشخص آخر وحقيبة أخرى مفخخة أودت بحياة الغشمي، وتكهن الكثيرون أن اغتياله كان فعلا انتقاميا لقتل الحمدي، قام به صديقه سالم ربيع علي رئيس اليمن الجنوبي" . إلا أن اغتيال هذا الأخير في 26 يونيو أي بعد يومين فقط من مقتل الغشمي، أكد لدى الكثير أن الغشمي وسالمين كانا ضحية مؤامرة مدبرة من قبل أكثر العناصر تطرفاً في قيادة الجبهة القومية، وأدت تلك الأحداث الدموية إلى احتدام التوتر بين الشطرين، وزاد من تفاقمها تولي عبد الفتاح إسماعيل أكثر العناصر تشدداً، زمام الأمور في السلطة في الجنوب، وهو المعروف بميوله الراديكالية، وبطموحه القاضي بالسيطرة على السلطة في شمال البلاد وتوحيدها تحت راية الماركسية، ومع بداية العام 1979 أصبحت الظروف بين الشطرين مواتية للحرب، وساعد على زيادة حدتها تدخلات القوى الإقليمية في الجزيرة العربية، وتصاعد حملاتها الدعائية ومحاولتها التخلص من النظام في الجنوب عبر مواجهة مسلحة شاملة، وفي 24 فبراير 1979 تفجر الصراع بين الشطرين ودخلا في حرب شاملة على طول الحدود، وبنفس الطريقة التي انتهت إليها الحرب عام 1972، انتهت كذلك الحرب عام 1979، بعد بذل جهود عربية فاعلة لاحتواء الموقف، إلى اتفاق وحدوي تمخض عن لقاء القمة الذي جمع بين الزعيمين "علي عبد الله صالح" و"عبد الفتاح إسماعيل" في الكويت في الفترة من 28-30 مارس 1979، وتضمن البيان المشترك للقمة اتفاق الرئيسين على ما يلي :- • تقوم اللجنة الدستورية بأعداد مشروع دستور دولة الوحدة خلال فترة أربعة اشهر. • عند انتهاء اللجنة الدستورية من أعمالها يعقد الرئيسان لقاءً لإقرار الصيغة النهائية لمشروع الدستور الدائم ودعوة كل منهما لمجلس الشعب في الشطرين للانعقاد خلال مدة يتفق عليها الرئيسان من تاريخ إقرارهما للصيغة النهائية التي يقدم بها مشروع الدستور إلى مجلس الشعب في كل من الشطرين للموافقة عليه كمشروع. • يقوم رئيسا الشطرين بعد ذلك بتشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على الاستفتاء العام على مشروع الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة والانتهاء من ذلك خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ تشكيلها. • يقر الرئيسان التقيد والالتزام الكامل بالمضمون والأحكام الواردة في اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس وقرارات مجلس الجامعة العربية وتنفيذ القرارات والتوصيات التي توصلت إليها لجان الوحدة. • يتولى رئيسا الدولة في الشطرين متابعة إنجاز عمل اللجنة الدستورية في الموعد المحدد ونتائج أعمال اللجان الأخرى من خلال لقاءات دورية في اليمن في كل من الشطرين. 4) الخطوات العملية لتحقيق الوحدة اليمنية منذ عام 1980 وحتى 22 مايو 1990. في ابريل 1980، قدم "عبد الفتاح إسماعيل" استقالته وسط انتقادات من بعض قيادات الحزب الاشتراكي واتهامه بتصعيد الموقف مع الشمال إلى درجة الحرب، وحل محله "علي ناصر محمد" وفي إطار مساعيه في البحث عن فرص أفضل لتحقيق الاستقرار السياسي وتحسين الظروف الاقتصادية للبلاد انتهج الرئيس "علي ناصر محمد" سياسة أكثر انفتاحاً مع دول الجوار وشهدت عدن حدوث انفراج في العلاقات مع تلك الدول، وقام الرئيس "علي ناصر محمد" بزيارات إلى الرياض، وأبو ظبي، والكويت في يوليو 1980م، وقامت الكويت والإمارات بجهود وساطة بين عدن والرياض وعلى صعيد العلاقات مع الشطر الشمالي عمل الرئيس "علي ناصر" على تعزيز العلاقات مع النظام في الشمال لاسيما مع إقبال صنعاء على تحسين علاقاتها مع موسكو وطمأنة السوفيت بنواياها الإيجابية تجاه النظام الجديد في الجنوب، وقام بوقف الدعم العسكري الذي كانت تقدمه عدن لـ "الجبهة الوطنية الديمقراطية المسلحة" المعارضة للنظام في الشطر الشمالي، ورفض مطالب الجبهة بالتدخل لفك الطوق المحكم الذي فُرض عليها من قبل القوات الحكومية في عام 1982 حتى انتهى الأمر بالقضاء عليها . وبتخلي كل طرف عن دعم القوى المعارضة للطرف الآخر تحقق قدر من الثقة بين قيادتي الشطرين، وقد وفر ذلك القدر من الثقة مناخاً مناسباً لمواصلة السير نحو إتمام عملية الوحدة، ونتيجة لاستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية في الشطرين، شهد عقد الثمانينيات من القرن المنصرم، عهداً جديداً من التواصل المنتظم في اللقاءات والمشاورات. سواء على مستوى لقاءات القمة أو على مستوى اللجان الوزارية المشتركة أو عبر سكرتارية المجلس اليمني الأعلى. فخلال عقد الثمانينيات تم عقد سبعة عشر لقاء قمة على مستوى رئيسي الشطرين، تمت بالتناوب بين صنعاء وعدن وتعز، هذا بخلاف اللقاءات التي تمت بين قيادتي الشطرين أثناء القمم العربية الاستثنائية. وعلى مستوى اللجنة الوزارية المشتركة بكامل هيئاتها عقدت اجتماعاتها سبع مرات، ذلك بخلاف اللقاءات الثنائية بين الوزراء والوفود للمناقشة في القضايا الفنية المعلقة والمختصة بها هذه الوزارة أو تلك. أما على مستوى المجلس اليمني الأعلى الذي تم تشكيله في ديسمبر عام 1981، فقد عقد أربعة لقاءات دورية. وعلى مستوى سكرتارية المجلس اليمني الأعلى والمختصة بتنفيذ ومتابعة ما يصدر عن لقاءات القمة بين الشطرين، فقد عقدت 13 اجتماعاً تمت بالتبادل بين الشطرين . ولتتبع سير عملية تلك اللقاءات ومنجزاتها خلال عقد الثمانينيات، فقد انعقد أول اللقاءت خلال هذه المرحلة في عدن، جمع بين الرئيس علي ناصر محمد، وبين عبد العزيز عبد الغني، رئيس الوزراء في الشطر الشمالي، وفيه "تم الاتفاق على تحديد المسائل الملموسة للتنسيق والتعاون بإنشاء المؤسسات المشتركة وبإدارة مشتركة للمشاريع الاقتصادية والخدمية في مجالات الصناعية والمعادن والمواصلات والمصارف والتنمية والسياحة" . وفي الفترة من 9-13 يونيو 1980، زار الرئيس "علي ناصر محمد" الشطر الشمالي والتقاء بالرئيس "علي عبد الله صالح" وصدر عن اللقاء بيان مشترك أكد فيه الزعيمان على ضرورة الإسراع بالخطى الوحدوية، وتنفيذ كل الاتفاقات السابقة، وأشار البيان أن الزعيمين استعرضا ما توصلت إليه اللجان الفنية في الجانب الاقتصادي وتم تدارس الخطوات العملية لتنفيذها على ضوء اتفاق عدن الموقع بتاريخ 6 مايو 1980م ، وفي ختام الزيارة صدر بيان آخر في 13 يونيو أعلن فيه الرئيسان اتفاقهما على عدد من الأمور الجوهرية في توطيد العلاقات بين الشطرين تمثلت في النقاط التالية :- • التعاون على توطيد الأمن والاستقرار في شطري اليمن بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة. • عودة المواطنين الراغبين في العودة إلى أي شطر من الوطن. • عـدم دعم إي نشاط سياسي أو عسكري أو إعلامي مناهض أو مضاد أو معاد لثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر وللسيادة الوطنية والديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي يسير على أساسها النظامين الوطنيين في الشطرين. • العمل على إزالة المواقع العسكرية في مناطق الأطراف في الشطرين وعلى أن تحل محلها قوات الشرطة الاعتيادية أو قوات رمزية عسكرية يتفق عليها الطرفان. وتكليف الأخوين وزير الدفاع في الشطر الجنوبي من الوطن ورئيس هيئة الأركان العامة في الشطر الشمالي من الوطن بتحديد أماكن تمركز القوات اليمنية. • وضع خطة للدفاع عن الأرض اليمنية والحفاظ على السيادة الوطنية. • أن يتم اللقاء الدوري بين رئيسي شطري اليمن مرة كل أربعة اشهر من اجل متابعة تنفيذ الاتفاقيات والقرارات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والخطوات اللاحقة. وبعد لقاء يونيو 1980 توالت لقاءات قيادتي الشطرين في سبتمبر 1980 بمدينة تعز، وسبتمبر 1981 في مدينة تعز أيضاً، إلا أن أهم وأبرز تلك اللقاءات تمثل في اللقاء الذي انعقد في مدينة عدن في 30 نوفمبر 1981 خلال زيارة قام بها الرئيس علي عبد الله صالح للجنوب تمخض اللقاء عن الاتفاق على خطة مشتركة سميت اتفاق تطوير التعاون والتنسيق بين شطري الوطن، تضمنت اتفاق الطرفين على توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين الشطرين على كافة الأصعدة في المجالات السياسية والثقافية والإعلامية والاقتصادية، وإنشاء آليات مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وتنسيق الجهود باتجاه إتمام عملية الوحدة، ولعل من أبرز ما تضمنه هذا الاتفاق :- • إنشاء مجلس من رئيسي شطري اليمن يسمى (المجلس اليمني) . يختص بمتابعة سير تنفيذ اتفاقيات الوحدة بين شطري الوطن والإشراف على أعمال لجان الوحدة . والإطلاع على ما اتفقت عليه لجان الوحدة وما ترفعه إليه من نتائج أعمالها والمصادقة على ذلك وإصدار التعليمات والتوجيهات الكفيلة بتنفيذ ما تمت المصادقة عليه. واستعراض كل ما يهم الشطرين من قضايا داخلية وخارجية والاتفاق على ما ينبغي اتخاذه من إجراءات بصددها. كما تم الاتفاق على تشكيل سكرتارية تابعة للمجلس اليمني يكون لها مكتبين مكتب في صنعاء ومكتب في عدن . وأن يجتمع المجلس اليمني الأعلى بصفة دورية مرة كل ستة أشهر ويحق له الاجتماع متى كان ذلك ضرورياً. وأن تعقد اجتماعاته بالتناوب في الشطرين. • إنشاء لجنة وزارية مشتركة من الشطرين تتكون من: رئيسي الوزراء أو من ينوب عنهما، وزيري الخارجية، وزيري الداخلية، وزيري التنمية والتخطيط، وزيري التربية والتعليم، رئيسي هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وتختص بالإشراف على تنفيذ المشاريع المشتركة التي تضمنتها الاتفاقيات الموقعة بين الشطرين، وضمان التنسيق بين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشطرين، وتقديم الدراسات والتقارير والمقترحات إلى المجلس اليمني والهادفة إلى دعم خطوات الوحدة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الشطرين. • تم الاتفاق على منح الحق لكل مواطن من مواطني الشطرين الانتقال من شطر لآخر بالبطاقة الشخصية العادية طبقاً للشروط والضوابط الواردة في الاتفاقية الموقعة بين وزيري داخلية الشطرين بتاريخ 12/6/1980م. • الاتفاق على توحيد المواقف الخارجية تجاه المحيط الإقليمي والدولي. وفيما كانت اللجنة الدستورية المشتركة قد انتهت من إقرار المسًّودة الأولى من مشروع الدستور في 30 ديسمبر 1981م تواصلت اللقاءات بين الجانبين على مختلف مستوياتها لمتابعة سير عملية الوحدة وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، ويمكن القول أن الأمور قد سارت سيراً حسناً وطبيعياً إلى أن تفجر الوضع في الجنوب في 13 يناير 1986، حيث نشب صراع دامي بين أجنحة الحكم في عدن أوقع بالشعب اليمني في الجنوب خسائر بشرية ومادية فادحة فقد أودى بحيات مالا يقل عن "أربعة عشر ألف قتيل وفق بعض المصادر، ونحو سبعة مليارات دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي" وانتهى الصراع بإزاحة الرئيس "علي ناصر محمد" من السلطة وخروجه من البلاد مع مجموعة كبيرة من مناصريه (قدرت بعشرات الآلاف) إلى الشطر الشمالي حيث أقيمت لهم معسكرات في المنطقة الوسطى في "رداع" و "ذمار" . لقد كان لتلك الأحداث انعكاساتها السلبية على مشروع الوحدة حيث أدت إلى تأخر العمل الوحدوي نحو أكثر من عامين وكان السبب في ذلك "تركيز السلطة الحاكمة في الجنوب لجهودها على استيعاب آثار الأزمة، وانتظار السلطة في الشمال للنتائج التي سيفرزها الوضع الجديد، وساهم وجود فريق الرئيس علي ناصر محمد في الشمال في زيادة حدة الحذر المتبادل بين الطرفين، خصوصاً أن اختلافاً في توصيف الأزمة وسبل حلها عرف طريقه بين السلطة الجديدة في الجنوب ونظيرتها في الشمال، حيث بدأ الشماليون أقرب إلى اعتبار أن ما جرى هو انقسام في السلطة، وأن الطابع الدموي له لا يعني اتخاذ خطوات ذات طابع عدائي وصراع أكثر، وأن المخرج يكمن في الدخول في حوار بين جناحي السلطة المتصارعين" ومن هذا المنطلق "بذلت صنعاء جهوداً للتوسط بين طرفي الصراع لتحقيق مصالحة وطنية إلا أنها لم تكلل بالنجاح بسبب فداحة الخسائر التي مني بها الطرفان في الحرب وتصلب كل طرف" "ذلك فضلاً عن اختلاف الطرح الشمالي جوهرياً عن طرح السلطة في الجنوب التي أكدت على عدم التصالح مع هذا الفريق أياً كانت النتائج، وأخذت بدورها في إتباع أسلوب قانوني للإجهاز على أنصار فريق الرئيس علي ناصر من خلال إحالتهم للتحقيق والمحاكمة واتهامهم بالخيانة، وقد مثل ذلك أحد بؤر التوتر الكامن في العلاقات بين الشطرين خلال تلك الفترة التالية للاقتتال الداخلي في الجنوب" . وبسبب تلك التغيرات دخلت العلاقات بين الطرفين مرحلة القطيعة التامة "باستثناء محاولة وساطة بذلها الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي لجمع رئيسي الشطرين، وبالفعل تم اللقاء بين الرئيسين في طرابلس في يوليو 1986م ولكن الاجتماع فشل لإصرار "حيدر أبو بكر العطاس" على اتهام الرئيس علي عبد الله صالح بالضلوع في أحداث يناير" "ومع استمرار تعثر حل مشكلة الرئيس علي ناصر محمد ومناصريه، بدأ أن المخرج هو استمرار وجوده في صنعاء شريطة عدم القيام بأي نشاط معاد للسلطة الجديدة في الجنوب، وترافق ذلك مع إعلان رغبات متبادلة بتنشيط اتفاقات الوحدة المعلن عنها من قبل "ومع إعلان الشطر الجنوبي عن اكتشاف النفط في منطقة حدودية مشتركة مع الشطر الشمالي دخل النفط كمتغير جديد ضمن المتغيرات الحاكمة لعلاقات الشطرين، ومع أن الشطرين كانا قد اتفقا على مبدأ الاستغلال المشترك للنفط الذي يتم اكتشافه في المناطق الحدودية المتداخلة، فقد بدا أن هناك خلافات جوهرية حول عملية تطبيق هذا الاتفاق المبدئي، وزاد من حدة المشكلة أمران: الأول، وجود تداخل بين حدود المناطق الممنوحة لشركات التنقيب، وكانت إحداها أمريكية تعمل بامتياز من السلطة الشمالية في مأرب، والثانية سوفيتية بامتياز من السلطة في الجنوب، وتعمل في محافظة شبوة. أما الأمر الثاني، فهو أن حسم المشكلة بعيداً عن مبدأ الاستغلال المشترك كان يعني بالضرورة اللجوء إلى تحديد صارم للحدود بين الشطرين، أو بالأحرى اتخاذ خطوة عملية من شأنها التناقض جوهرياً مع مطلب الوحدة اليمنية، وهو ما كان يصعب من الناحية السياسية والمعنوية على أي من السلطتين الحاكمتين الدعوة إليه أو القبول به، لما له من مردودات عكسية يصعب تبريرها وتمريرها دون معارضة شعبية ملموسة. وقد تبلور آنذاك خياران أمام القيادتين السياسيتين، إما تنشيط العمل الوحدوي المشترك بصيغته الشاملة، وإنهاء فترة التردد والحذر والعمل على احتوائها كاملة، وإما التمهيد لمواجهة مفتوحة وشاملة تعصف بما تم إنجازه على صعيد عملية الوحدة، ولم يكن الخيار صعباً إذ اختارت القيادتان في الشطرين خيار تنشيط العمل الوحدوي" وجاء أول اجتماع في مدينة "تعز" التي شهدت خلال الفترة من 16 - 17 أبريل 1988 عقد لقاء قمة بين الزعيمين علي عبد الله صالح، وعلي سالم البيض، تمخض عنها اتفاق الجانبين على ما يلي :- • استكمال جهود قيادتي الشطرين في احتواء ومعالجة آثار أحداث 13 يناير 1986م المحزنة في الشطر الجنوبي من الوطن. • الالتزام الكامل والتنفيذ فيما سبق أن توصل إليه الشطران في العمل الوحدوي قبل أحداث يناير 1986م في كافة المجالات، وأهمية تنشيط أعمال الهيئات واللجان الوحدوية القائمة بين الشطرين. • يكلف لقاء القمة اليمني سكرتارية المجلس اليمني الأعلى، بإعداد البرنامج الزمني المتعلق بمشروع دستور دولة الوحدة لإحالته إلى مجلس الشعب في الشطرين ومن ثم الاستفتاء عليه في ضوء الاتفاقيات الوحدوية بين الشطريــن. • حرصاً من قيادتي الشطرين على إزالة كل أسباب التوتر بين الشطرين يكلف لقاء القمة رئيسي هيئة الأركان بتحديد نقاط التمركز لقوات الشطرين على أطراف محافظتي مأرب وشبوه، وتخفيف القوات في هذه المواقع وتحديد حجمها، وكذلك تحديد النقاط المشتركة بين مواقع قوات الشطرين على ضوء الوضع الراهن ، لضمان عدم الاحتكاك وتجنب أي أخطاء بينها مستقبلاً، مع عدم استحداث أي مواقع جديدة من قبل الشطرين في كل الاتجاهات في المنطقة، وفي هذا الإطار يؤكد لقاء القمة على عدم اللجوء إلى المواجهة المسلحة في كل أشكالها بين الشطرين، واستبعاد ذلك كليةً باعتماد الحوار والتفاهم كوسيلة وحيدة لمعالجة أي مشكلة قد تطرأ. • يؤكد لقاء القمة على أهمية المشروعات الاستثمارية ومنها ما يتعلق بالاستثمار المشترك للثروات الطبيعية بين محافظتي مأرب وشبوه، وان تستكمل الخطوات العملية الخاصة بتنفيذه. وفي أعقاب ذلك الاجتماع حدث خلاف بين الشطرين بسبب أعمال التنقيب عن النفط في "رملة السبعتين" وهي منطقة حدودية تقع في محافظة الجوف، وتوتر الموقف بشدة على الحدود وكاد يصل حد المواجهة العسكرية بين الطرفين، إلا أن القيادتان تمكنتا بسرعة عبر اتصالات متبادلة من احتواء الموقف وكان نتيجة تلك الاتصالات أن تم عقد لقاء قمة آخر في صنعاء في الفترة من 3-4 مايو 1988م تمخض عن اتفاق الجانبين على مجموعة أمور لعل أبرزها يتمثل في النقاط التالية :- • الإسراع في أن تنجز سكرتارية المجلس اليمني الأعلى المهمة التي كلفها بها لقاء تعز الماضي في إعداد البرنامج الزمني المتعلق بمشروع دستور دولة الوحدة وإحالته إلى مجلسي الشعب في الشطرين ومن ثم إنزاله للاستفتاء عليه وفقاً للاتفاقيات الوحدوية بين الشطرين. • إحياء لجنة التنظيم السياسي الموحد المنصوص عليها في المادة التاسعة من بيان طرابلس تحقيقاً للنوايا الصادقة وترجمة للخطوات الوحدوية حتى يصل الجانبان لتصور مشترك للعمل السياسي الموحد طبقاً للاتفاقيات وان تنهي اللجنة أعمالها خلال اقرب وقت ممكن. • استكمال جهود قيادتي الشطرين في احتواء ومعالجة آثار أحداث 13 يناير 1986م المحزنة والتعاون على توطيد الأمن والاستقرار في شطري اليمن بكافة الوسائل الممكنة. • إقامة مشروع استثماري مشترك بين محافظة مأرب وشبوه بمساحة قدرها 2200 كم مربع ألفان ومائتان كيلومتر مربع. • لتسهيل حركة تنقل المواطنين بين الشطرين تم الاتفاق على: أن يُسمح للمواطنين بالتنقل والمرور عبر النقاط المشتركة بالبطاقة الشخصية وعدم فرض القيود على المواطنين من قبل الأجهزة في الشطرين. خلال عام 1989م صدر عن سكرتارية المجلس الأعلى واللجنة الوزارية المشتركة ولجنة التنظيم السياسي الموحد العديد من التوصيات والقرارات مهدت لاتفاق عدن التاريخي الذي تمخض عن لقاء القمة في 30 نوفمبر 1989م، والذي أسفر عن الاتفاق على الدستور وإحالته إلى مجلسي الشعب والشورى (السلطتين التشريعيتين في الشطرين) للموافقة عليه واستكمال كافة أعمال المجلس اليمني الأعلى واللجنة الوزارية واللجان المشتركة خلال فترة أقصاها شهران تمهيداً لإعلان الوحدة، وفي الفترة من 8 يناير وحتى 5 مايو 1990 عقدت عدة لقاءات قمة يمنية تم فيها استكمال الأعمال المناطة بمجلس الوزراء في الشطرين ولجنة التنظيم السياسي الموحد بما في ذلك اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية والاتفاق على تنظيم الفترة الانتقالية الذي تم في لقاء القمة في 22 أبريل 1990 . وفي 22 مايو 1990 تم إعلان الوحدة اليمنية وعاصمتها صنعاء. ثانياً: الوحدة اليمنية: من حيث دلالاتها السياسية. يمكننا الحديث عن مستويين من الدلالات التي تثيرها الوحدة اليمنية، الأول، المستوى المحلي أو الوطني، والثاني، المستوى الإقليمي. الدلالات على المستوى المحلي أو الوطني. وتتمثل في إن الوحدة اليمنية التي تحققت في الثاني والعشرين من مايو 1990م، قد تمت بالوسائل السلمية المتمثلة في الاتفاقات المبرمة بين الشطرين منذ عام 1972م، وهي الاتفاقات التي لم تأتي من فراغ وإنما أتت من إيمان عميق لا يقبل الشك لدى كافة أبناء الشعب اليمني بأن الوحدة هي الوضع الطبيعي لليمن، وجاءت جميع اتفاقيات الوحدة وسط زخم جماهيري عارم يعشق الوحدة التي طالما حلم بتحقيقها وناضل من أجلها طويلاً حتى تحققت بإرادة شعبية خالصة رافضة للتشطير. ومن ناحية ثانية، فبعد أن أكدت وقائع التاريخ استحالة أن يهنأ الشعب اليمني بالأمن والاستقرار ومن ثم الرخاء والقوة طالما كان هناك واقع تشطيري للجسد اليمني الواحد، فإن الوحدة تُعد عامل أمن واستقرار لا غنى عنه للشعب اليمني، وتمثل أساساً متيناً لبناء يمن قوي ومزدهر، وللدلالة على مدى أهمية قيام الوحدة اليمنية على أمن واستقرار الشعب اليمني، يكفي الإشارة فقط إلى ما شهده اليمن بشطريه من حروب وأعمال عنف من أجل تحقيق الوحدة خلال العقدين السابقين من قيامها. الدلالات على المستوى الإقليمي. يمكن الحديث عن شقين من الدلالات السياسية الإقليمية للوحدة اليمنية، فأما الشق الأول، فيتمثل في أن الوحدة تعد عامل استقرار للبيئة الإقليمية، إذ أن بقاء التشطير يعد مصدراً لاستمرار التوتر والصراع في جنوب شبه الجزيرة العربية، وهو أمر لا بد وأن تكون له تداعياته السلبية على المحيط الإقليمي وخصوصاً دول الجوار الجغرافي المتصلة مع اليمن بحدود برية، وبالتالي فإن الوحدة اليمنية تعد عامل استقرار للمنطقة، لاسيما بعد أن تمكن اليمن خلال العقد الأول من زمن وحدته، من تسوية جميع مشكلاته الحدودية، مع جيرانه بالوسائل السلمية وهو أمر ما كان لأي زعيم يمني أن يتمكن من حسمه لو لم تكن هناك حكومة يمنية واحدة تتولى حل قضايا اليمن بأكمله شماله وجنوبه، وشرقه وغربه. وأما الشق الثاني للدلالات السياسية الإقليمية للوحدة اليمنية، فيتمثل في أن الوحدة اليمنية تعد مكسباً للأمة العربية والإسلامية، ومصدر قوة للقومية العربية، ومنجزاً أحيا الأمل في قلوب الكثير من الوحدويين العرب، بإمكانية تحقيق حلم إقامة دولة عربية واحدة تمتد من المحيط الأطلنطي إلى الخليج العربي، وفي هذا الشق يمكننا استنتاج دلالة أخرى من الوحدة اليمنية، تتعلق بدور الشعوب العربية في تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية، فقد أدى الإيمان العميق لليمنيين بوحدة التراب اليمني إلى استمرار الزخم الجماهيري العارم باتجاه الوحدة، وزود مسيرتها بطاقة فاعلة من الحماس الذي لا ينضب، جعلها تتجاوز كل الصعوبات التي أعاقت تقدمها، فلا الخصومات السياسية بين قادة الشطرين، ولا المؤامرات الخارجية، تمكنت من تحويل مسارها أو التقليل من شأنها، وعليه فإن إيمان الجماهير العربية بوحدة الأمة العربية التي تربطها الكثير من الروابط الجغرافية والتاريخية واللغوية والثقافية والدينية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة، يجعلها قادرة على توفير الزخم الجماهيري العربي الذي يمهد الطريق لقيام وحدة عربية، وكما أن للتجربة الوحدوية اليمنية خصوصيتها في شكلها، فإن للوحدة العربية خصوصيتها أيضاً، لكن الأهداف الأساسية تظل هي نفسها، والمضمون الوحدوي يظل واحد في كلتا الحالتين. ثالثاً: الوحدة اليمنية من حيث الأبعاد. يمكننا الحديث عن أربعة أبعاد للوحدة اليمنية هي على النحو الآتي:- البعد التاريخي والحضاري للوحدة اليمنية. تستمد الوحدة اليمنية قوتها وجذورها من أعماق التاريخ، فمنذ سنة 1500 ق.م وحتى أوائل القرن السادس الميلادي شيد اليمنيون في جنوب شبه الجزيرة العربية، ممالك عظيمة كانت من أكثر الممالك حضارة ورقي على مستوى المعمورة كلها خلال تلك العصور، وبعدها دخلت اليمن في صراعات داخلية وخارجية عملت على تمزيقها، غير أنها وكما أسلفنا سابقاً فسرعان ما كانت تعود للتوحد من جديد، وينظر اليمنيون إلى اليمن الطبيعية على أنها إرث أجدادهم الذي لا يمكنهم التفريط فيه، ولهذا فقد كانت الوحدة مطلباً شعبياً وحضارياً طوال تاريخ اليمن القديم والحديث. واليوم تمثل الوحدة اليمنية التي تمت في 22 مايو 1990م قدر الشعب اليمني ومصيره، خصوصاً بعد أن تعمدت هذه الوحدة بالدماء الزكية الغزيرة التي سُكبت بسخاء على الأرض اليمنية دفاعاً عن وحدة الوطن في مواجهة محاولة الانفصال والتجزئة في عام 1994م. وبات في حكم المؤكد أنه بعد أن أثبت الشعب اليمني عزمه وإصراره على التمسك بوحدته التي ناضل من أجلها زمناً طويلاً وقدم لأجلها التضحيات الجسام، أصبحت الوحدة اليمنية شيئاً مقدساً لدى عموم الشعب اليمني لا يجب أن يمس. البعد الاجتماعي للوحدة اليمنية. بالإضافة إلى ما أوضحنا سابقاً عن وحدة الأصل للإنسان اليمني (حيث يُرجع النسابون جميع أهل اليمن إلى قحطان جد العرب الأول) ووحدة الأرض التي عاش عليها الشعب اليمني منذ الأزل، فإن الوحدة اليمنية اليوم تستمد قوتها في بعدها الاجتماعي، من الدرجة العالية من التجانس الاجتماعي للشعب اليمني، الذي يعيش معظم سكانه في مستوى متقارب من الحياة المعيشية، ويكاد يخلوا من وجود عرقيات ثقافية، أو دينية، أو إثنية. اللهم إلا بعض الاختلافات المذهبية التي لا ترقى إلى مستوى التهديد لإستقرار الوحدة رغم محاولات البعض العزف عليها، ومحاولة استغلالها، لا لشيء إلا رغبة في استعادة زعامات تاريخية كانت أحد أسباب تمزق الشعب اليمني، غير أن هذا الشغب بات اليوم أكثر من أي وقت مضى متمسكاُ بوحدته التي ناضل من أجلها ردحاً طويلاُ من الزمن، ولن يقبل على نفسه التقسيم كما يُقسم القطيع بين الرعيان. البعد الاستراتيجي للوحدة اليمنية. يمكن الحديث عن البعد الاستراتيجي للوحدة اليمنية من خلال الثلاثة المستويات التالية، الأول، وهو المستوى المحلي، ويتمثل هذا البعد في أن الوحدة اليمنية تمثل القاسم المشترك الذي تجمع عليه وأجمعت عليه في الماضي كافة القوى السياسية باعتبارها الخيار الاستراتيجي الأفضل لقيام دولة يمنية حديثة وقوية وأكثر أماناً واستقراراً. لاسيما بعد أن اقترنت عملية الوحدة بعملية الديمقراطية، وإتاحة حرية التعددية السياسية والحزبية وحرية التعبير داخل البلاد، الأمر الذي يتيح لكافة القوى والتنظيمات السياسية المشاركة في العملية السياسية، وهذا بدوره يعد مكسباً من مكاسب الوحدة. أما المستوى الثاني، فهو المستوى الإقليمي، ويتمثل في أن الوحدة اليمنية جعلت اليمن يحتل مكانة إقليمية مرموقة وزادت من وزنة الاستراتيجي بين دول المنطقة، حيث أصبح اليمن يمتلك مقدرات وإمكانيات من عناصر القوة لم يكن يمتلكها في زمن التشطير، فبالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي الهام، وحيازته لمجموعة من الجزر الاستراتيجية الواقعة في البحر الأحمر والبحر العربي، يمتلك اليمن طاقات بشرية هائلة قادرة على النهوض بالبلاد فيما لو تم استغلالها، ذلك فضلاً عن امتلاك اليمن لثروات طبيعية واعدة. وعليه فإن اليمن الموحد أصبح أكثر قدرة على التأثير في محيطه الإقليمي. وأما المستوى الثالث للبعد الاستراتيجي للوحدة اليمنية، فيتمثل في زيادة حجم مكانة اليمن الدولية لدى دول العالم، وزيادة المصالح الاقتصادية لكثير من الدول الكبرى لدى اليمن خصوصاً النفطية منها، بالإضافة إلى ذلك فإن تحقيق الوحدة اليمنية يضمن قدراً أكبر من الأمن والاستقرار في المنطقة التي تعتبر أهم المناطق الاستراتيجية للطاقة في العالم، خاصة وأن اليمن تقع بالقرب من هذه المناطق وتشرف على أهم طرق عبور النفط للعالم الصناعي من الخليج عبر بحر العرب ومضيق باب المندب. البعد القومي للوحدة اليمنية. تمثل الوحدة اليمنية لبنة أساسية في بناء الوحدة العربية الشاملة، وتعتبر نصر تاريخي للأمة العربية ضد واقع التجزئة والتفرقة الذي تعاني منه هذه الأمة. وقدمت التجربة اليمنية الدليل الواقعي لإمكانية قيام وحدة عربية شاملة. من ناحية أخرى فمثلما أن الوحدة اليمنية تعد مصدر قوة لليمن فإنها بالضرورة كذلك تشكل مصدر قوة للعرب جميعاً. الجزاء الثاني سيشمل الظروف والتحديات التي عايشتها الوحدة ومراحل تطورها وصولاً إلى حرب عام 1994م. |
|
التعديل الأخير تم بواسطة فؤاد ناصر البداي ; 06-17-2006 الساعة 02:07 PM |
|
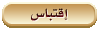
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| احصا ئيات عن القران لا تفوتكم معرفتها | باحرس1970 | سقيفة الحوار الإسلامي | 30 | 10-14-2012 12:40 AM |
| فضل يوم الجمعة | تاج العليب فؤاد باطويح | سقيفة إسلاميات | 1 | 07-01-2011 11:11 AM |
| جيش رجال الطريقة النقشبندية /جانب من العمليات الجهادية الغير مصورة /من 8-15/ 10 /2010 | ابن ميسان | سقيفة الأخبار السياسيه | 1 | 10-20-2010 10:55 PM |
| مجلة السياسة الخارجية الأمريكية: يجب على دول الخليج أن تقبل اليمن عضواً في مجلس التعا | حد من الوادي | سقيفة الأخبار السياسيه | 0 | 10-10-2010 01:14 AM |
|
|